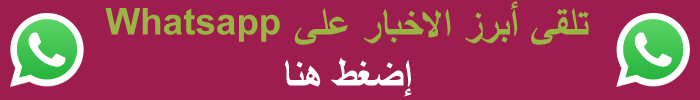كتب وسام صافي في الإقتصاد والأعمال:

في لحظة مفصلية من التاريخ العربي الحديث، وفي الثالث من مارس عام 1965، وقف الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة على أرض مدينة أريحا مخاطبًا الجماهير الفلسطينية والعربية بخطاب خرج عن المألوف. ففي زمن كانت تسيطر فيه الشعارات الثورية على الخطاب السياسي العربي، وتتنافس فيه الأنظمة على من يرفع سقف الوعد بتحرير فلسطين “من البحر إلى النهر”، اختار بورقيبة أن يتحدث بلغة العقل، لا العاطفة، وبمنطق الواقع لا الحماسة. دعا بورقيبة في خطابه الشهير إلى تبني قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، كحل مرحلي في مسار طويل لاستعادة الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن “السياسة فن الممكن”، وأن التشبث بالأحلام الكاملة دون نظر في ميزان القوى العالمي قد يقود إلى ضياع كل شيء.
لكن خطابه، بدل أن يلقى الإصغاء والتأمل، قوبل بتنديد واسع من قادة وزعماء الجمهوريات “الثورية”، الذين رأوا فيه انحرافًا عن الإجماع القومي وخيانة لفلسطين. اليوم، وبعد أكثر من ستة عقود من الحروب والهزائم والخذلان، يُعاد فتح دفاتر الماضي، ويظهر خطاب بورقيبة كنداء عقلاني ضاع في ضجيج الشعارات، وكمحاولة رصينة للخروج من المأزق التاريخي الذي قادت إليه الأنظمة الشعبوية.
رؤية بورقيبة: واقعية سياسية
انطلق بورقيبة في خطابه من تجربة تونس في الاستقلال، حيث اختارت قيادته التفاوض التدريجي مع فرنسا، وانتزاع المكاسب على مراحل بدل المواجهة العسكرية المفتوحة. وعليه، اعتبر أن نهج “خذ ثم طالب“، أي القبول بالدولة الفلسطينية على جزء من الأرض، قد يكون مدخلًا عقلانيًا لحفظ حقوق الفلسطينيين وتثبيتها على الساحة الدولية. الخطاب، الذي وثق لاحقًا في عدد من المصادر الأكاديمية والإعلامية، من بينها أرشيف الرئاسة التونسية وترجمات نشرها مركز كارنيغي والباحث التونسي محمد كريم الأزرق، كان في جوهره دعوة إلى استخدام أدوات الشرعية الدولية، والاستثمار في الساحة الدبلوماسية بدل خوض حروب خاسرة سلفًا.
شعارات كبرى وواقع هش
في الجهة المقابلة، اختارت الأنظمة الجمهورية الوليدة، في مصر وسوريا والعراق والجزائر، نهجًا نقيضًا. فبينما تبنّت خطابات مدججة بالمصطلحات الثورية، كانت الحقيقة أن هذه الأنظمة لم تكن تملك لا الاستعداد العسكري الكافي، ولا البنية السياسية القادرة على خوض صراع طويل النفس. جمال عبد الناصر قال في خطاباته: “سوف نلقي بإسرائيل في البحر“. حافظ الأسد تبنّى شعار: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة“. صدام حسين صدّح بـ: “فلسطين طريق الوحدة، والوحدة طريق فلسطين“.
لكن هذه الشعارات، التي دوخت الجماهير وألهبت مشاعرها، كانت في الغالب غطاءً لعجز استراتيجي عن تحقيق أي انتصار فعلي. فسرعان ما جاءت نكسة حزيران عام 1967، كزلزال سياسي وعسكري دمر ما تبقى من الثقة الشعبية في الأنظمة، وأظهر أن صخب الخطاب لم يكن سوى صدى لفراغ استراتيجي عميق.
فلسطين ذريعة للاستبداد
من المفارقات المرّة أن القضية الفلسطينية، التي شكلت وجدان العرب الجمعي، تحوّلت في يد هذه الأنظمة إلى أداة داخلية للقمع ومصادرة الحريات. رفعت أنظمة الحكم شعارات مقاومة الاستعمار والصهيونية، لكنها في الوقت ذاته حلّت الأحزاب وقيدت التعددية السياسية، قمعَت النقابات والحركات الطلابية، فرضت الرقابة على الصحف والمنابر الإعلامية، وشرعنت عسكرة الدولة باسم “الاستعداد للمعركة الكبرى“.
وقد استُخدمت “فلسطين” كمبرر لقوانين الطوارئ في مصر، والتجنيد الإجباري المفتوح في العراق وسوريا، وللتصفية السياسية في الجزائر بعد الاستقلال. بل إن المعارضة التي كانت تدعو لتحرير فلسطين بوسائل مستقلة جرى اتهامها بـ “العمالة” أو “التواطؤ مع الصهيونية“، في مفارقة تجعل من فلسطين – رمز التحرر – وسيلة للاستعباد المحلي.
وفي السنوات الأخيرة، وثّقت منظمات حقوقية كيف تم تكميم الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل بعض الدول العربية، كما حصل في مصر في مظاهرات عام 2021 و2024، حيث مُنع المتظاهرون من التعبير عن دعمهم لغزة خوفًا من “زعزعة الأمن الداخلي”.
إيران وتوظيف قضية فلسطين: من التحرير إلى الهيمنة الإقليمية
مع الثورة الإيرانية في 1979، سعت طهران إلى استثمار قضية فلسطين لتحقيق مصالحها الإقليمية الخاصة، حيث تحولت القضية إلى ورقة ضغط في صراعها مع الغرب والدول العربية المتحالفة معه. إيران استغلت الفراغ العربي الذي خلفته الهزائم المتتالية، لتقديم نفسها كـ “حامية” لفلسطين، رغم عدم وجود حدود جغرافية أو تاريخية لها مع فلسطين. طهران قامت بدعم فصائل فلسطينية مثل حماس وحزب الله، لكنها في المقابل كانت تستخدم القضية الفلسطينية لتوسيع نفوذها الإقليمي في لبنان والعراق واليمن، مما حول القضية من قضية تحرير إلى أداة صراع إقليمي.
بات واضحًا أن شعار “تحرير فلسطين” في الخطاب الإيراني يحمل تناقضًا جوهريًا: فبينما ترفع طهران راية التحرير، فإنها تقوض الدول العربية القادرة على دعم الفلسطينيين فعليًا. الأكثر إيلامًا هو أن إيران نفسها تقمع الأقليات العربية داخل حدودها (كالأهواز)، ودعمت نظام الأسد في سوريا لعقود الذي دمّر نصف الشعب السوري، وورطت لبنان وغزة بمعارك نتائجها كارثية بينما تتغنى بـ”المقاومة”.
خيانة موهومة وبصيرة ضائعة
عند النظر إلى المدى الطويل، يتضح أن الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأنظمة العربية في الستينيات والسبعينيات، والذي كان يرفع شعارات ضخمة عن تحرير فلسطين، قد ساهم في تدمير الفكرة الفلسطينية في ضوء الواقع العسكري والسياسي المتغير. اليوم، بعد مرور عقود من الهزائم والنكسات، أصبح خطاب بورقيبة أكثر من مجرد موقف عقلاني في ظل الانهيارات العسكرية والإقليمية. فقد كانت بصيرة بورقيبة هي ما يمكن أن يحفظ الحقوق الفلسطينية، بينما تم استخدام الشعارات الثورية لتبرير القمع الداخلي وتشويه القضية الفلسطينية لصالح الأنظمة التي فشلت في تقديم حلول واقعية.
أما في العقدين الأخيرين، فقد برزت إيران كقوة إقليمية تسعى لتوظيف قضية فلسطين لخدمة مصالحها الاستراتيجية. فقد نجحت طهران في تسويق نفسها كحامية للقضية الفلسطينية، رغم غياب أي ارتباط تاريخي أو جغرافي مع فلسطين. إيران استخدمت القضية كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال دعم حزب الله الحشد الشعبي الحوثي وحماس، وتحقيق مصالحها في لبنان والعراق واليمن. لكنها في المقابل، حولت القضية الفلسطينية من قضية تحرير حقيقية إلى أداة صراع إقليمي، مما أضعف الموقف الفلسطيني الموحد وأدى إلى مزيد من التشرذم والانقسام في الساحة العربية.
وهكذا، أصبحت القضية الفلسطينية ضحية لخطاب الثورات والشعارات الزائفة، سواء من الأنظمة التي استغلتها لتعزيز سلطتها الداخلية أو من إيران التي حولت دعمها للفلسطينيين إلى أداة لتحقيق أجندتها الإقليمية.