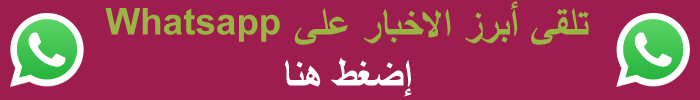كتب جوزف الهاشم في الجمهورية:
جاء في كتب التاريخ، أنّ الشاعر الفرنسي «لامرتين» عندما زار الشرق قال: «وجدتُ في مصر حاكماً ولم أجدْ شعباً، ووجدتُ في لبنان شعباً ولمْ أجدْ حاكماً».
ماذا… ألا نزالُ نفتقدُ حكمَ الحاكم، فإذا كلّ شأنٍ عندنا ثنائي: الحكمُ حكمان، الدولة دولتان، الوطن وطنان، والشعب في الثنائيات شعوبٌ وعشائر؟
هل يعود بنا المشهد التاريخي إلى ما قبل الإستقلال: ثلثُ لبنان سوري، وثلثُه الآخر فرنسي، والثالث يتجاذبُه الجانبان؟
هناك جدلِّيةٌ غامضة لا تزالُ تُطرحُ في أذهان المراقبين: هل العلاقة التي تربط شيعةَ لبنان بدولة إيران، وسنَّة لبنان بالدول العربية، ومسيحيّي لبنان بدول الغرب، ودروز لبنان بجبل السويداء وفلسطين، والعلويّين في لبنان بالعلويّين في سوريا؟
هل هذه العلاقة التي تربط طوائف لبنان بمثيلاتها خارج لبنان، هي التي تزعزع الترابط فيما بينها داخل لبنان، فيشكّل الإنتماء الطائفي جدليةً متضاربة مع الإنتماء الوطني؟
البيئة الجغرافية: هي العاملُ الأكبر في تكييف الشعوب وتحديد مصيرها القومي، وهي التي تكوّنُ كياناً شعبياً مميّزاً وكياناً مميّزاً في الحضارات.
الموارنة في لبنان هم غير الموارنة في قبرص، وهكذا شأن المسلمين في الهند، فإذا كان الأساس واحداً، إلّا أنّ البيئة الجغرافية مختلفة، وهناك علاقة تراثية بالأرض لا يمكن فصلُها عن الإنسان، «وهي تدخل في تكوينهِ البيولوجي والنفسي»، كما يقول إبن خلدون.
يمكن أن تشكِّلَ الصلةُ الطائفية بين الداخل والخارج تفاعلَ غنىً في الشأن الحضاري والتراثي الإنساني، من دون أنْ تؤّدي إلى تناقض تاريخي وانقسام وطني.
يقول الشاعر بشارة الخوري «الأخطل الصغير»: «إذا شئنا أنْ يكون لنا وطنٌ مستقلّ، فعلينا ألّا نبيع إبنَ وطننا المسلم بألوف النصارى الأجانب عنّا، وألّا نبيع إبنَ وطننا المسيحي بألوف المسلمين الأجانب عنّا» (1).
هنا تكمن المشكلة، المشكلة عندنا هي مشكلة كيانية، وكلّما كان هناك خلاف حول المفاهيم الأساسية للمعنى القومي والسيادة الوطنية نتذرع بالنظام والدستور، ونهوّلُ بالحرب الأهلية.
السيادة بحسب إعلان حقوق الإنسان الفرنسي 1789: هي مبدأ مصدرُهُ الشعب، وعندما لا يتوحّد الشعب كلُّ الشعب حول مفهوم واحد للسيادة، يصبح هناك خللٌ تكويني وتروح معه هواجس المكوّنات الوطنية تفتّشُ عن صِيَـغَ بديلة، تنقذ التصادم بالدم.
عندما اصطدم الرئيس كميل شمعون بالإنقسام اللبناني حول السيادة الوطنية بدافع أجنبي، راح يطرح الفدرالية (2).
وحين اصطدم الرئيس سليمان فرنجية بالإنقسام الوطني السيادي «إعتبر أنّ الفدرالية هي الحـلّ» (3).
وفي الظروف ذاتها يقول الرئيس الياس سركيس: «إذا لم يَعُد بإمكاني تحقيق التوحيد، يجب الإتجاه نحو تركيبةٍ تنتظمُ في داخلها وحداتٌ طائفية لكلٍّ منها استقلالها الذاتي» (4).
هذا لا يعني: أنّني أدعو إلى الفدرالية نظاماً، بقدر ما أعني وجوب تحاشي المحاذير، لنجمع فدرالياتنا الجغرافية والطائفية والعقائدية في إطار الوطن السيد الفدرالي الواحد الذي هو الحلّ.
وإنّني أعني ما عناه «مارتن لوثر كينغ» الذي قاد مسيرة الإحتجاج على الفصل العنصري بين السود والبيض في أميركا فقال: «علينا أنْ نتعلم العيش معاً كأخوة وإلّا فسوف نهلك معاً كأغبياء…».
1 – الأخطل الصغير – الأعمال النثرية: ص 253.
2 – شمعون: الفدرالية وإلّا وقع التقسيم: جريدة الأحرار: 25/11/1978.
3 – مذكرات فؤاد بطرس: 14/3/1978.
4 – كريم بقرادوني: السلام المفقود: ص 158.