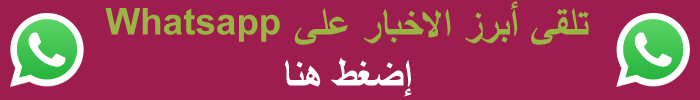مرّ قرار سحب «اليونيفيل» من الجنوب، بعد نحو عامين، وكأنّه حدث عادي. لكنه في الواقع ينطوي على خطر كبير، ولو متأخّر. فإذا فشل لبنان وإسرائيل، وسوريا أيضاً، في ترسيخ وقف النار وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا لم تُنجَز اتفاقات «متوازنة وعادلة» في شأن الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود البرية، فإنّ حدود لبنان السيادية الدولية ستكون بلا حماية، مشرّعةً لإسرائيل. وهذه الحماية هي المغزى العميق لوجود «اليونيفيل» على الحدود.
بذل الإسرائيليون جهوداً مضنية لمنع التجديد لـ«اليونيفيل». في المقابل، سعى الفرنسيون ومعهم أوروبيون وعرب إلى التمديد لهذه القوات روتينياً، وربما مع بعض الصلاحيات الإضافية. فجاءت التسوية أميركية: تمديد أخير حتى نهاية 2026، يتمّ تنفيذه تدريجاً خلال 2027، أي أنّ اكتمال الانسحاب يتحقق بعد نحو سنتين. وفحوى هذه التسوية هو إعطاء لبنان وإسرائيل فرصة للتوصل إلى اتفاق أمني، وربما سياسي، ينهي التوترات، فيأتي سحب «اليونيفيل» بعد ذلك في موقعه الصحيح.
لكن المشهد يبدو في الواقع أشدّ تعقيداً. وثمة أبعاد خطرة لمضمون التمديد الأخير. فانسحاب «اليونيفيل» سيكون نقطة تحوّل محورية في الواقع الجيوسياسي في جنوب لبنان، في ظل توازنات دقيقة. فعندما أرسل مجلس الأمن قوات «اليونيفيل» إلى الجنوب، بناءً على القرار 425، كان يريد قطع الطريق على المخاوف التي تسبّب بها اجتياح إسرائيل في العام 1978. وعندما قرّر تدعيم قواتها وفقاً للقرار 1701، كان يريد مساعدة الجيش والدولة اللبنانية على تكريس الحضور في الجنوب، بعد حرب تموز 2006 المدمّرة.
ووفقاً للتسلسل المنطقي للأحداث، كان يفترض صدور قرار جديد عن مجلس الأمن، بعد الحرب الأخيرة، يكون أكثر حزماً وفاعلية في التعاطي مع «حزب الله» وإسرائيل في آن معاً، فيسمح لـ«اليونيفيل» بأن تساعد الجيش بقوة على تسلم أمن الجنوب وحده.
المعطيات السائدة لا تسمح بقرار كهذا. وعلى العكس، بذل الإسرائيليون كل جهد لطرد «اليونيفيل» من الجنوب، فيما «الحزب» من جهته بدا حذراً جداً في قبول أي دور أمني لها، خارج الدوريات الروتينية ومستوصفات الأدوية. وتكفّل «الأهالي» بهذه المهمّة. وهذا الأمر أفرح الإسرائيليين، لأنّه اعطاهم مبرراً إضافياً للقول إنّ «اليونيفيل» عاجزة أمام «الحزب».
ولكن، بعد حين، سيكتشف لبنان أنّه أُصيب بخسارة كبيرة بقرار سحب «اليونيفيل»، لأنّ وجودها يتجاوز المهمّات الأمنية إلى كونه رمزاً دولياً لسيادة لبنان على حدوده المعترف بها. ففي عرف الديبلوماسية الدولية، يُعدّ وجود قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة تأكيداً على الاعتراف الدولي بحدود دولة ما. وعندما يُتّخذ قرار بإنهاء مهمّة هذه القوات، من دون التوصل إلى اتفاق يكرّس الحدود الدولية، فمن الممكن أن يُفسَّر ذلك بأنّه رفع للحماية الدولية عن هذه الحدود، ما يُخلّف فراغاً أمنياً وسياسياً خطراً.
الأمر يشبه رفض إسرائيل لوجود وكالة «الأونروا» لمجرد أنّها تمثل شرعية وجود شعب فلسطيني. وسعي إسرائيل إلى اقتلاع «اليونيفيل» فوراً يعكس رغبتها في حرّية التحرّك بلا قيود، خصوصاً بعد حرب الـ11 شهراً. فوجود القوات الدولية يقيّد تحركاتها العسكرية. لكن واشنطن الراغبة في احتواء التوتر خشيت أن يؤدّي الانسحاب المفاجئ لهذه القوات إلى تصعيد قد يخرج عن السيطرة، فمنحت الطرفين المعنيين فرصة إضافية للحل الديبلوماسي. وفي الوقت عينه، أرادت مسايرة الحلفاء كفرنسا والدول العربية.
الآن، يجد لبنان نفسه أمام تحدّي عدم التوصل إلى اتفاق شامل مع إسرائيل قبل الموعد المحدّد لانسحاب «اليونيفيل»، لأنّ إسرائيل، في ظل الفراغ، ستسمح لنفسها بالتصرّف استنسابياً في الجنوب، بدعم واشنطن، أو على الأقل بغض نظر منها.
يُمكن لإسرائيل، في غياب «اليونيفيل»، أن تتوسّع جغرافياً في سيطرتها، أو أن توسّع دائرة عملياتها العسكرية، أو أن تستمر في سياسة التهجير التي مارستها في حربها الأخيرة. وهذا السيناريو كابوس للبنان الذي سيفقد حماية دولية ولو رمزية توفّرها «اليونيفيل»، ما يجعله عرضةً لانتهاكات إسرائيلية مفتوحة. فهل أرادت واشنطن الضغط على لبنان ليقبل بالتسويات ضمن فترة زمنية محدّدة، تحت طائلة الفوضى؟
وفق هذا التصور، إنّ تمديد ولاية «اليونيفيل» لنحو سنتين عملياً هو في حقيقته سباق مع الزمن. وهو يحمّل لبنان المسؤولية عن قبول الحل الديبلوماسي الذي يجنّبه عواقب الانسحاب، ويستبطن إنذاراً خطراً بانتهاء فترة الحماية الدولية، ويستثير الهواجس من الدخول في مرحلة جديدة من التوتر والفراغ الذي لا يهدّد أمن لبنان فحسب، بل أيضاً سيادته وحدوده المعترف بها دولياً، أي سلامة أرضه ككيان.