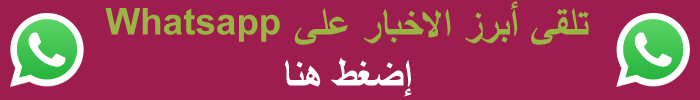كتب جوزف القصيفي في الجمهورية:
لا يمكن للسلام في الشرق الأوسط أن يكون شاملاً إذا لم يكن عادلاً. ومعيار العدالة يكون بالتزام قرارات الشرعية الدولية بصرف النظر عن القراءة المتباينة لهذه القرارات وتقويمها. وإسرائيل منذ زرعها الغرب كيانا مصطنعاً، غريباً في قلب المنطقة، لم تمتثل يوماً لأي قرار صادر عن الأمم المتحدة. فهي رفضت القرار 194 /48 الذي يضمَن حق العودة للفلسطينيِّين الذين هُجِّروا من أرضهم قسراً بفعل المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وفي مقدّمها «الهاغاناه»، وهي أيضاً لم تعترف بالقرار رقم 242 الذي ينصّ على معادلة الأرض مقابل السلام ولم تشرع في تنفيذه.
وتُعتبَر الدولة العبرية حالياً محمية غربية في عالم عربي يُراد له أن يظل مفكّكاً سليب الإرادة، تتناحر دُولِه في ما بينها. وإنّ بعضها يخاصم البعض الآخر كما لو أنّه إسرائيل. وهذا الأمر كانت له تداعيات سلبية على جامعة الدول العربية التي أضحت شليلة، وخاضعة دائماً للمحور الأقوى والأكثر إقتداراً، ممّا نفى عنها صفة الحكم، ودفعها إلى الإنحياز إلى مَن رُجِّحت كفّته بحسب اتجاه الريح لدى اللاعبين الكبار المؤثرين. والشرق الأوسط بات راهناً في المدار الأميركي – الإسرائيلي الذي يرسم له أدواره ووظائفه، وربما خرائطه. ومَن يراقب ما يجري في سوريا من مذابح واضطرابات على قاعدة طائفية وإتنية على نحو عزّز الإنقسام الداخلي في هذا البلد الذي عرف منذ نشأة الدولة فيه بمركزية حكمه، يتبيّن له أنّ الحدود التي خطّها الثنائي سايكس – بيكو أصبحت عرضة للتعديل. مع فارق أساس وهو أنّ الدم الغزير الذي سيَسيل هو البديل عن القلم. وما يُخشى منه أن تنتقل العدوى إلى لبنان الذي تتفاعل على أرضه مخاوف مكوّناته الطائفية والمذهبية كافة من دون فظاظة في التعبير عنها، ولكل مكوّن أسبابه واعتباراته التي يراها مشروعة، فيما تغذّيها إسرائيل بما تتقن من أساليب سياسية وأمنية صارت معروفة.
إذاً المشكلة السياسية التي ألبِست لبوساً وجودياً ستبقى قائمة، ومن الصعب الإجابة عمّا إذا كان «اتفاق الطائف» قادراً على توفير حل لها يساعد في بناء دولة موحّدة (بأي صيغة؟!)، أو أنّ الحاجة إلى رؤية أخرى قد يستحيل صَوغها على البارد. ولم يَعُد خافياً الهمس الذي يدور في كواليس جهات مسيحية وازنة، وبصيغة التساؤل: هل كان خيار لبنان الكبير خياراً صائباً؟ هل من طرح يحافظ على وحدة الأرض ويحافظ على الخصوصيات في آنٍ، إذا ظل الإلتباس قائماً حول عدد من المشتركات؟ ومثل هذا الحذر والخوف ليس مقتصراً على المسيحيِّين، فللشيعة هواجسهم جراء نتائج «حرب الإسناد» عسكرياً وسياسياً واجتماعياً. وللدروز مخاوفهم بعد أحداث السويداء ومجازرها، وارتفاع أصوات تجاهر بالإدارة الذاتية في تلك المنطقة بضمان إسرائيل وحمايتها، الأمر الذي حمل النائب السابق وليد جنبلاط على التصدّي لهذا التوجّه، مُعرّضاً نفسه وموقعه إلى تحدّيات كبيرة شهد اللبنانيّون وقائعها على الأرض. أمّا السُنّة، فليسوا أفضل حالاً كما يعتقد البعض، فهناك مواجهة مستمرة تطفو على السطح أحياناً بين الإعتدال الذي يحتل موقعاً ثابتاً داخل الطائفة، والتطرّف الأصولي والتكفيري الذي يمتطي موجة المتغيّرات في المنطقة، وكان آخرها سقوط نظام بشار الأسد ووصول أحمد الشرع إلى رئاسة الجمهورية.
إنّ لبنان هو بلد الهويات المقتتلة التي ما تلبث أن تتحوّل إلى هويات قاتلة بفعل المتغيّرات الدولية والإقليمية التي تُرخي بثقلها عليه. ومشكلته تتجاوز الحصص والنفوذ إلى ما هو أعمق. أي إلى شجاعة الإعتراف بأنّ إرادة العيش معاً من دون إسقاط الحذر، لا تبني استقراراً دائماً وثابتاً، بل تُعمّق ثقافة الكُمون لدى هذا الطرف أو ذاك.
هل يعني ذلك السكوت؟ لا يفترض مواجهة الواقع بسلوك النعامة، بل بشجاعة المسؤول، وهنا يأتي دور النُخَب لتتحمّل مسؤولياتها في الإجابة عن أكثر من سؤال:
أولاً: هل لا يزال «اتفاق الطائف» قادراً على معالجة مشكلة لبنان بكل أبعادها، إذا ما استكمل تنفيذ كامل بنوده؟
ثانياً: إذاً تبيّن عجز «اتفاق الطائف» عن الإحاطة بالمشكلة، ووضع ركائز لحل مستدام، هل هناك قدرة على البحث عن صيغة بديلة تكون بمثابة إعادة تأسيس للوطن الذي أراده حاملو لواء لبنان الكبير موئلاً للحرية، وحاضناً للتفاعل الإيجابي بين طوائفه الدينية في إطار حوار الحضارات الذي يُشكِّل نقيضاً لنظرية صموئيل هنتنغتون بحتمية صدامها وإفراز الأحاديات الحاكمة للكون؟!
ثالثاً: هل في إمكان اللبنانيِّين صَوغ مناعة وطنية تقي وطنهم الإهتزازات، وكيف يكون ذلك من دون إرادة الحياة معاً، وهي لا تزال موجودة ويمكن البناء عليها؟
أياً تكن الإعتبارات، إنّ الحرب الأخيرة على لبنان فتحت الباب على تحدّيات كبيرة وأسئلة خطيرة، لن تكون الإجابة عنها ممكنة في المستقبل المنظور.