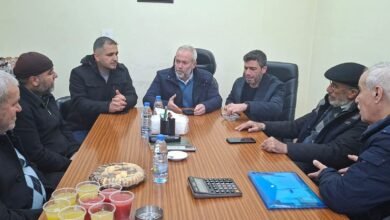كتبت جومانا زغيب في نداء الوطن:
يضحك قيادي سيادي بارز عندما يسأله محدثوه في مجلس خاص: وماذا تردّون على جماعة الممانعة عندما يتهمونكم بأنكم تسعون إلى التطبيع مع إسرائيل، لا سيما في حال نجحت الدولة في تطبيق قرار حصر السلاح بيدها؟ ويجيب: “هذه التهمة ومثيلاتها تلاحقنا منذ عقود طويلة، ونحن في الأصل لا نوليها اهتمامًا، لأن موقفنا معروف وهو أن لبنان لن يوقّع أي سلام أو يلتزم أي تطبيع مع إسرائيل إلا إذا وجد إجماعًا عربيًا على ذلك أو أقله سارت الأكثرية الساحقة من الدول العربية لا سيما المهمة منها، في هذا الخيار، وحينها لكل حادث حديث”.
ويضيف “إن لبنان يتمايز في العلاقة مع إسرائيل عن سواه، بأن بينه وبينها اتفاقية هدنة ما زالت قائمة ونافذة منذ تاريخ عقدها في 2 آذار 1949 في رأس الناقورة. ولذلك، لا بد من العودة إليها وتطبيقها من الجانبين بوجود دولة لبنانية ناجزة السيادة ويمكنها أن تكفل التنفيذ السليم لبنودها. وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه ثرثرات وذرًا للرماد في العيون، علمًا أن اتفاقية الهدنة تضم نقاطًا أفضل بكثير مما يعتقده البعض وأفضل من الاستمرار في حال استنفار دائم على قاعدة الاكتفاء بالتزام وقف إطلاق النار أو الأعمال العدائية من الجانبين. بل إن إسرائيل هي التي قد تكون الأكثر انزعاجًا لأن هناك بنودًا تلزمها بأمور وحيثيات تقع ضمن حدودها وتخضع لرقابة لجنة الهدنة ومراقبيها الدوليين”.
وللبيان، فإن اتفاقية الهدنة كما جاء في مقدمتها تمثل تدبيرًا موقتًا من أجل تسهيل الانتقال من المهادنة إلى سلم دائم في فلسطين. وليس للاتفاقية مهلة محددة تنتهي بنهايتها، لكنها تؤكد بوضوح أنه لا يجوز للقوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق الآخر أو قواته المسلحة، وهذا يعني عمليًا امتناع إسرائيل حتى عن إرسال طيرانها للتحليق فوق الأجواء اللبنانية ولو لغاية الاستطلاع.
وثمة نقطة مهمة تتضمنها الاتفاقية وهي تلتقي مع قرار حصرية السلاح التزامًا بوقف النار واتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، إذ ورد في المادة الثالثة أنه لا يجوز أيضًا لأي قوات عسكرية أو شبه عسكرية بما في ذلك القوات غير النظامية أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر أو ضد المدنيين في أراضيه.
والأهم، أن الاتفاقية نصّت في ملحق تحديد عديد وعدة القوات الدفاعية لكل من البلدين خارج خط الهدنة، وهو خط مرسوم بعمق معين لدى كل من البلدين في موازاة الحدود الدولية، ويعني ذلك أن هناك منطقة في لبنان شمالي خط الهدنة تصل حدودها إلى خط القاسمية مرورًا بالنبطية التحتا وصولًا إلى حاصبيا، تنتشر فيها قوات لبنانية محدودة مع عتادها ومحددة بما لا يتجاوز الـ 1500 عسكري، والأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل وصولًا إلى الخط العام جنوبي الحدود اعتبارًا من نهاريا مرورًا بترشيحا والجش حتى ماروس.
ومن هنا، فإن الخطوة اللاحقة المنطقية قبل الوصول إلى أي تطبيع أو سلام تتمثل بترسيم الحدود بشكل نهائي مع إسرائيل، علمًا أن مسألة مزارع شبعا تخضع للقانون الدولي، وأي تعديل في واقعها يحتاج إلى اعتراف سوري رسمي بلبنانيتها أو على الأقل بالتفاوض حولها والأفضل برعاية معينة إقليمية أو دولية.
وفي أي حال، وبمعزل عن مسألة المزارع، فلا بد من ترسيم حاسم للحدود اللبنانية السورية للخلاص من المبررات المختلفة في ما خص التهريب ووجود ثغرات وخلافات حول نقاط حدودية معينة يتم استغلالها بشكل أو بآخر لا سيما على صعيد التهريب بمختلف أشكاله، فضلًا عن استمرار بذور نزاع دائم حول مساحات ومشاعات ملتبسة. ولذلك، الأولوية هي لتحديد الحدود وصولًا إلى ترسيمها بدقة عبر وضع العلامات وتثبيت المسوحات والاستعانة بنظام الـ GPS. وهذا يعني استكمال شروط التطبيع مع الدولة السورية والانطلاق نحو إرساء صفحة جديدة من العلاقات السوية. وهذا الأمر يريح لبنان جنوبًا وشرقًا وشمالًا، ويحرره من الابتزاز ومحاولات استغلاله كساحة تحوّله عمليًا إلى أسير يعاني بين المطرقة الإسرائيلية والسندان السوري، ولو اختلف التوصيف لكل منهما بالعدو أو بالشقيق.
وهذا الواقع المرتجى يبقى في جانب أساسي منه رهن قرار لبناني رسمي شجاع ونهائي بتطبيع الوضع اللبناني، ضمن شروط معينة تكفل وجود دولة ناجزة قرارًا ومؤسسات، تؤمن الانتظام العام من جهة، وتكرس الطابع التعددي المتنوع للبنان كوطن فريد للشراكة والعيش المشترك المتوازن بما يتخطى حسابات الأحجام والأرقام.